فيروس كوفيد-19 وتآكل نظام اللجوء في أوروبا
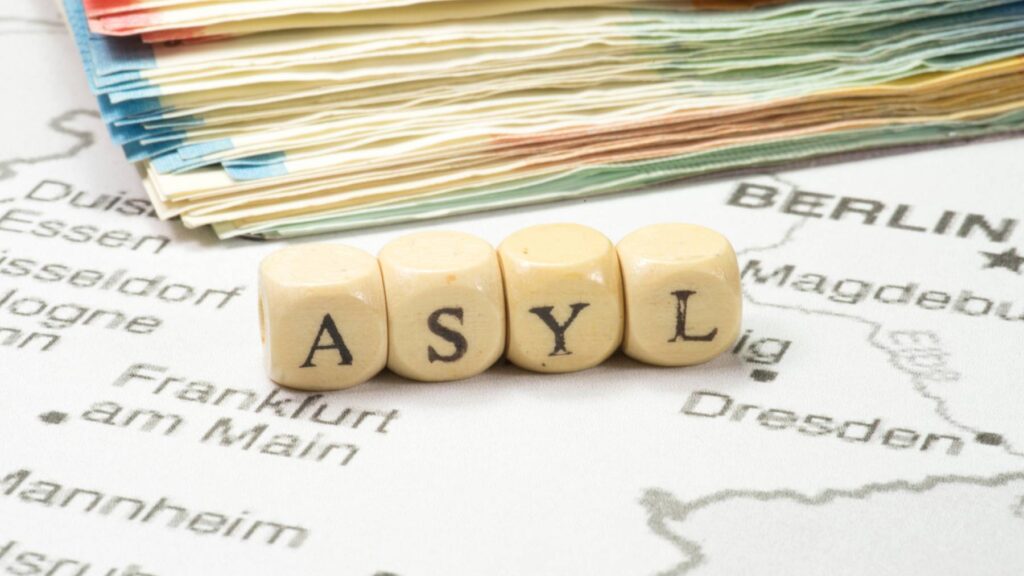
برزت أوروبا في وقت مبكر جدا كواحدة من أولى “النقاط الساخنة” لفيروس كوفيد-19 في العالم. في البداية، حظيت سلسلة من السياسات العشوائية، بما في ذلك عمليات الإغلاق غير المنسقة وإغلاق الحدود، وحتى الدول التي ترفض المساعدات المالية والطبية لجيرانها، بانتقادات كبيرة من المجتمع الدولي. ولكن في الآونة الأخيرة، تحول المد بالنسبة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث اتجهت أعداد الحالات والإصابات نحو الانخفاض، وتخفيف قيود الإغلاق، وفتح الحدود، وتعافي الاقتصاد تدريجيا. قبل أيام فقط، وافق قادة الاتحاد الأوروبي على حزمة اقتراض مشتركة ضخمة للمساعدة في ضمان تعافي الاتحاد الأوروبي بعد فيروس كورونا. حتى الآن يتم الإشادة بالدول الأوروبية على نطاق واسع لتعاملها مع الأزمة. ومع ذلك، لا يزال هناك مجال واحد من غير المرجح أن تحظى فيه استجابة أوروبا بعد كوفيد بالثناء في أي وقت قريب: معاملة طالبي اللجوء. في الواقع، إن الانتشار الهائل للسياسات التي تستهدف سلبا طالبي اللجوء الموجودين بالفعل في الاتحاد الأوروبي وأولئك الذين ما زالوا يأملون في القدوم يثير شكوكا جدية حول مستقبل اللجوء في أوروبا تماما.
قبل تفشي المرض في 2019، قدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن ما يقرب من 123,633 لاجئا وطالب لجوء ومهاجرا غير شرعي دخلوا الاتحاد الأوروبي، معظمهم من سوريا والعراق وأفغانستان. وصلت الغالبية العظمى عبر طريق البحر الأبيض المتوسط إلى إسبانيا وإيطاليا واليونان بينما دخل عدد أقل بكثير عن طريق البر عبر البلقان. ولكن في النصف الأول من عام 2020، وعندما بدأ الوباء يجتاح أوروبا، انخفض العدد التقديري للاجئين الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي بشكل كبير إلى 31,834.
لم يتباطأ دخول طالبي اللجوء فقط منذ بداية الوباء ، ولكن أيضا عدد طلبات اللجوء المقدمة. وفقا للمكتب الأوروبي لدعم اللجوء (EASO)، تم تقديم 8,730 طلب لجوء فقط في أبريل من عام 2020، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 87٪ عن يناير. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن هذا هو أقل عدد من طلبات اللجوء المسجلة في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2008.
ومع ذلك، فإن هذا الانخفاض الحاد في طلبات اللجوء وطلبات اللجوء ليس نتيجة لانخفاض عالمي في الطلب على الحماية الدولية. بل إنه يعكس حقيقة مفادها أن أوروبا ذاتها لم يعد من الممكن الوصول إليها.
أساس القانون الدولي للاجئين هو اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين (وبروتوكول عام 1967 اللاحق)، التي تنص على أن اللاجئ هو أي شخص يعبر حدودا دولية من أجل طلب الحماية “بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد” (المادة 2). ولكن ماذا لو أغلقت الحدود الدولية؟ ماذا لو رفضت الدول قبول طلبات اللجوء؟ هذا هو بالضبط الوضع الذي دق أجراس الإنذار للوكالات الإنسانية، حيث أغلقت حوالي 170 دولة حدودها استجابة لوباء كوفيد-19، 57 منها لا تستثني اللاجئين.
كجزء من هذه الاستجابة العالمية لانتقال الفيروس ، بحلول منتصف مارس ، قامت قلعة أوروبا المحصنى أيضا بتحصين حدودها الخارجية. وبينما تمكنت حكومات الاتحاد الأوروبي من تنظيم رحلات جوية مستأجرة لنقل المواطنين والمقيمين وحتى العمال المهاجرين الأساسيين الذين يعملون على الخطوط الأمامية أو في الزراعة، لم يتم إجراء مثل هذه الاستثناءات لأولئك الذين ينتظرون عند بوابات أوروبا لطلب اللجوء. جاءت الضربة الكبرى الأولى لطالبي اللجوء في أوروبا في فبراير/شباط عندما أعلن الرئيس التركي أردوغان أن تركيا لن تمنع طالبي اللجوء من محاولة دخول الاتحاد الأوروبي عبر اليونان. وقبل ذلك، وافق الاتحاد الأوروبي على دفع أموال لتركيا مقابل إبقاء طالبي اللجوء على أراضيها وإرسال اللاجئين الذين تم فحصهم مسبقا إلى أوروبا فقط. لم تعد تركيا على استعداد للعمل ك “غرفة فرز” للاتحاد الأوروبي. وردا على ذلك، أغلقت اليونان حدودها وأعلنت أنها لن تنظر بعد الآن في أي طلبات لجوء من الوافدين غير الشرعيين. وترك الآلاف من طالبي اللجوء عالقين على الحدود البرية، ووفقا لتقارير منظمة العفو الدولية، اتهم حرس الحدود اليونانيون باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه وحتى الذخيرة الحية لإبعاد المهاجرين.
في أوائل أبريل، اتخذت إيطاليا خطوة غير مسبوقة بإعلان موانئها “غير آمنة”، مشيرة إلى ارتفاع معدلات الإصابة في البلاد. لم يمنع هذا فقط قوارب المهاجرين غير الشرعيين الذين يقومون بعبور البحر الأبيض المتوسط الخطير من ليبيا من الرسو، ولكن أيضا أي قوارب إنقاذ تحمل مهاجرين انقلبت قواربهم في الرحلة. ولأسباب مماثلة، أصدرت مالطا أمرا بعدم إنزال السفن التي تحمل مهاجرين. كما وجد رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا نفسه قيد التحقيق بتهمة التقاعس الجنائي بعد وفاة خمسة مهاجرين في قارب لم يتم الرد على إشارة استغاثة قبالة ساحل مالطا في أبريل. في مايو/أيار، أعلنت المجر إغلاق حدودها “إلى أجل غير مسمى” أمام المهاجرين، وبدأت في فرض تقديم أي طلب لجوء في البلدان المجاورة، قبل دخول المجر.
المشكلة في عمليات إغلاق الحدود هذه ليست فقط أنها غير أخلاقية بشكل واضح، ولكن يبدو أنها تنتهك القوانين الدولية. على سبيل المثال، غالبا ما يكون عبور الحدود الدولية خطوة ضرورية في عملية طلب اللجوء، لذا فإن الحدود المغلقة تضعف بشكل خطير حقوق المهاجر بموجب اتفاقية عام 1951. كما أن إرسال قوارب المهاجرين للخروج من المياه الأوروبية هو أيضا انتهاك واضح لعدم الإعادة القسرية، التي تحظر على الدول إعادة المهاجرين إلى ظروف غير آمنة (المادة 33). ويتحدى العنف الذي يواجهه المهاجرون على أيدي دوريات الحدود في جميع أنحاء أوروبا المعايير التي حددها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقوانين حقوق الإنسان في أوروبا.
ماذا عن طالبي اللجوء الموجودين بالفعل على الأراضي الأوروبية؟ لسوء الحظ، الأمور ليست أفضل بكثير. على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي مبني على فكرة حرية الحركة عبر حدوده الداخلية،17 من أصل 26 دولة شنغن أعادت فرض إغلاق الحدود، مما أدى إلى تعقيد وضع اللاجئين إلى حد كبير. على سبيل المثال، بعد إغلاق الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي لأسباب تتعلق بالصحة العامة، رفضت العديد من الدول نقل اللجوء من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى على النحو المنصوص عليه في لائحة دبلن. يتطلب نظام دبلن من طالبي اللجوء التقدم بطلب للحصول على اللجوء في بلد الدخول الأول، وهو محتقر من قبل الدول المثقلة بالأعباء على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي حيث يدخل معظم المهاجرين.
كما أوقفت العديد من الدول الأوروبية مؤقتا تسجيل طلبات اللجوء والبت فيها. وبعبارة أخرى، لا يستطيع المهاجرون حتى تقديم وثائق لطلب اللجوء. في الممارسة العملية، كان هذا يعني أن أي طالب لجوء في أوروبا بشكل غير قانوني لم يتمكن من الوصول إلى أي من شروط الاستقبال المتاحة عادة لمقدمي الطلبات، مثل السكن أو الطعام، أو حتى الوضع القانوني ل “طالب اللجوء”. إن خطر تزايد أعداد الأشخاص الضعفاء قانونيا الذين يعيشون خارج النظام، وفي فقر مدقع، هو مصدر قلق حقيقي. في فرنسا، أمرت أعلى محكمة في البلاد في نهاية المطاف الحكومة الفرنسية بإعادة تسجيل طالبي اللجوء لتجنب هذه القضية على وجه التحديد.
وأولئك المحاصرون في مخيمات اللاجئين في أوروبا هم من بين الأسوأ حالا. يجعل اكتظاظ المخيمات التباعد الاجتماعي مستحيلا، ويمكن أن يؤدي الوصول المحدود إلى المرافق الطبية أو النظافة إلى تسريع انتشار أي فيروس. على سبيل المثال، تم بناء مخيم موريا في اليونان لإيواء 3 آلاف لاجئ، ولكنه بدلا من ذلك يضم 20 ألفا، وتشير التقديرات إلى أن هناك صنبور مياه واحد متاح لكل 1,300 نسمة. لقد انتشر فيروس كورونا بالفعل كالنار في الهشيم في مخيمات أخرى، مثل مخيم إلوانغين للاجئين في ألمانيا. تؤكد التحقيقات في ظروف مراكز احتجاز المهاجرين أن المحتجزين قد يواجهون مخاطر مماثلة، من حيث الاكتظاظ ومحدودية الوصول إلى الرعاية الطبية.
ولكي نكون منصفين، خففت بعض البلدان من بعض السياسات الأقل قابلية للدفاع. على سبيل المثال، اختارت السويد وإيطاليا وبلجيكا إطلاق سراح مهاجرين مختارين من مراكز الاحتجاز، من أجل السماح بقدر أكبر من التباعد الاجتماعي. لقد ذهبت البرتغال إلى أبعد من غيرها من خلال منح حق الوصول المؤقت إلى حقوق المواطنة لأي مهاجر لديه طلب جنسية أو لجوء معلق ، مما يسمح له بالمساواة في الوصول إلى الخدمات الصحية ومزايا الرعاية الاجتماعية. لكن هذه الممارسات هي استثناءات للقاعدة.
ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيتمكن من العودة إلى نظامه السابق، وإن كان غير كامل، في التعامل مع طالبي اللجوء، لا يزال سؤالا مفتوحا إلى حد كبير. إعادة التفكير في نظام جديد أكثر عدلا ربما أقل احتمالا. بعد كل شيء ، بالنسبة للعديد من السياسيين الأوروبيين، قدم الوباء فرصة ملائمة للمضي قدما أخيرا في قيود الحدود والهجرة التي نوقشت طويلا على أساس حماية الصحة العامة. الخوف الأكبر من ذلك كله هو أن هذه التدابير التقييدية المؤقتة يمكن أن تصبح دائمة بسهولة.
ربما تكون واحدة من أكثر الحقائق واقعية التي تم الكشف عنها خلال هذه الأزمة هي مدى خلل النظام. لا يقتصر الأمر على أن الاتحاد الأوروبي ليس لديه كفاءات في مجال الصحة العامة، ولكن يبدو أن العديد من المجالات التي يجب أن يتمتع فيها الاتحاد الأوروبي بالسلطة قد تم تجاهلها بسهولة في التدافع نحو الإغلاق. وبالمثل، فإن الحصول على خدمات الصحة العامة والرعاية الاجتماعية على المستوى الوطني غالبا ما يرتبط ارتباطا وثيقا بالوضع القانوني (وأحيانا المالي) ويستبعد بالتأكيد المهاجرين السريين. وبما أن الفيروس نفسه لا يميز بين الضعفاء، فإن أي ممارسة تهمش الضعفاء وتميز ضدهم تمثل تهديدا للصحة العامة وستظل تطارد جهود أوروبا للحد من الفيروس.
ذات يوم، لاحظ المؤرخ الأميركي فرانك سنودن أن الأوبئة أشبه بالمرايا التي تسمح للمجتمعات برؤية نفسها؛ ومن الواضح أن هذه الأوبئة لا يمكن أن تكون قادرة على رؤية نفسها. إنها تكشف نقاط ضعفنا وأولوياتنا السياسية وإنسانيتنا. السؤال الآن هو ما إذا كنا نحب ما نراه.
مقال بقلم أماندا غاريت، أستاذ مساعد في العلوم السياسية بجامعة جورجتاون في قطر.
- اقرأ المزيد عن مشروع COVID هنا.